بين كارنيجي والإسلام: من مهارات العلاقات إلى قيم الإيمان
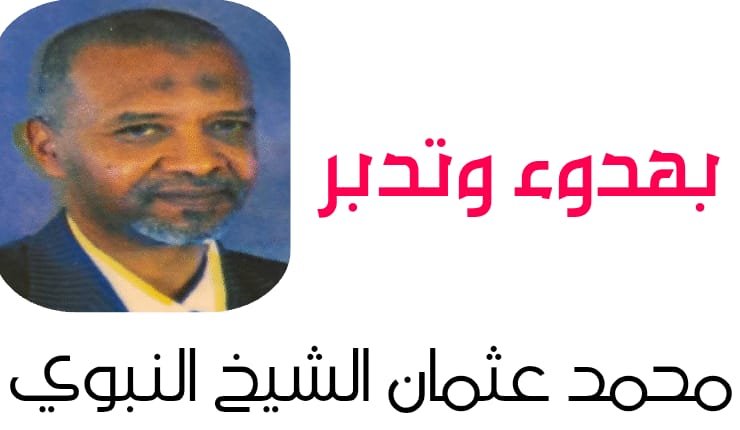
بهدوء وتدبّر
بقلم: محمد عثمان الشيخ النبوي
بين كارنيجي والإسلام: من مهارات العلاقات إلى قيم الإيمان
منذ أن نشر ديل كارنيجي كتابه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس عام 1936، تغيّرت نظرة العالم لفن العلاقات الإنسانية. فقد علّم ملايين القراء أن النجاح لا يقوم على الذكاء وحده، ولا على الشهادات أو المال، بل على القدرة على التعامل مع الناس. وضع كارنيجي قواعد بسيطة لكنها عميقة: لا تنتقد أحدًا، ابتسم، اهتم بالآخرين، تذكّر أسماءهم، استمع إليهم جيدًا، اجعلهم يتحدثون عن أنفسهم، وأشعرهم بأهميتهم. هذه المبادئ صنعت ثورة في العلاقات الاجتماعية والعملية، ولا تزال إلى اليوم تُدرَّس في الجامعات وتُستخدم في المؤسسات الكبرى.
وقد تُرجم هذا الكتاب إلى أكثر من ثمانٍ وخمسين لغة، وبيع منه ما يزيد على خمسٍ وثلاثين مليون نسخة حول العالم، ليصبح واحدًا من أكثر الكتب تأثيرًا وانتشارًا في القرن العشرين، بل لا تكاد تخلو منه مكتبة في الشرق أو الغرب. ولا تزال دور النشر تعيد طباعته وتحديث نسخه حتى اليوم، ويُدرّس في معاهد الإدارة وفنون التواصل بوصفه من كلاسيكيات التنمية البشرية الحديثة. هذا الانتشار الهائل لم يكن لسطحية الأسلوب، بل لعمق الفطرة التي لامسها في الناس جميعًا؛ إذ وجدوا في نصائحه صدىً لما تقتضيه الإنسانية من مودة واحترام، وإن جهلوا أن تلك المعاني مأخوذة من جذورٍ أسبق وأصفى.
لكن المفارقة أن هذه المبادئ التي أدهشت العالم الحديث ليست جديدة على الحضارة الإنسانية. ففي الإسلام، نجد أن هذه القواعد قد قُررت قبل قرون طويلة، لكن مع فارق جوهري: أن الإسلام لم يجعلها مجرد مهارات اجتماعية أو أدوات للنجاح المادي، بل جعلها قيمًا أخلاقية وعبادات يتقرب بها العبد إلى الله.
بل إن المنصف المتأمل يدرك أن ما دوّنه كارنيجي في القرن العشرين ليس إلا ظلالًا من نور الهدي النبوي الذي سبق إليه الإسلام بقرون، فكل قاعدة من قواعده تجد أصلها في سلوك النبي ﷺ أو في توجيه قرآني كريم. غير أنه — شأن كثير من المفكرين الغربيين — نقل الجوهر دون أن يشير إلى المصدر، فغابت الروح وبقيت المهارة. وبلا ريب فإن كارنيجي قد استقى كثيرًا من هذه المبادئ من التراجم المنتشرة آنذاك لمعاني القرآن الكريم وسيرة النبي ﷺ، فقد كانت تلك الترجمات تُتداول في الغرب وتؤثر في نتاج الفكر الإنساني الحديث، وأسهمت في تشكيل الرؤية الأخلاقية لعدد من كبار المفكرين والأدباء من أمثال غوته وروسو وتولستوي، حتى امتدت آثارها إلى مدارس التنمية البشرية وفنون القيادة في القرنين التاسع عشر والعشرين، فصاغها كارنيجي في ثوبٍ عمليٍّ مبسّط دون أن يربطها بمصدرها الأصيل.
كارنيجي يوصي بعدم انتقاد الآخرين، لأن النقد يولّد العناد. والقرآن الكريم يختصر هذه الفلسفة في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، أي اجعلوا خطابكم كله طيبًا لينًا، لأن الكلمة القاسية تهدم ما لا تبنيه الجيوش. والنبي ﷺ يقول: “ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء”، ليرسم حدودًا واضحة للسلوك القولي الذي يبني العلاقات بدلًا من أن يهدمها.
أما الابتسامة التي جعلها كارنيجي أداة ذهبية للتأثير، فقد جعلها الإسلام صدقة يؤجر عليها المرء: “تبسمك في وجه أخيك صدقة.” فهنا تتحول ابتسامة بسيطة إلى عبادة، يجمع بها المسلم بين نشر الفرح وكسب الحسنات.
كارنيجي يشدد على أهمية تذكّر أسماء الناس لأنها أقرب طريق إلى قلوبهم. والنبي ﷺ كان ينادي أصحابه بأحب أسمائهم إليهم، حتى الأطفال كان يمازحهم بأسمائهم، فيشعر كل فرد بقيمته. وقد ورد أن النبي ﷺ كان يكنّي الأطفال فيقول للصغير: “يا أبا عُمير ما فعل النُغَير؟” فيمازحه بكنية الكبار، ليزرع في قلبه شعورًا بالاحترام والاعتبار.
وفي فن الإصغاء، نجد أن كارنيجي يدعو إلى أن يُحسن الإنسان الاستماع للآخرين، ويشجّعهم على الحديث عن أنفسهم، لأن ذلك يفتح قلوبهم ويكسب مودّتهم. بينما الإسلام سبق إلى ذلك حين جعل حسن الاستماع من مكارم الأخلاق، وقد عُرف عن النبي ﷺ أنه كان يصغي لمحدثه بإقبالٍ كامل، فلا يقطع كلامه، بل يُحسن الاستماع له حتى يفرغ من قوله. ومن الأمثلة المشهورة أن أحد الأعراب شدّ النبي ﷺ بردائه حتى أثر في عنقه، وطالبه بعطاء، فما غضب منه ﷺ ولا ردّ عليه بقسوة، بل ابتسم وأمر له بالعطاء، فحوّل الموقف من عداء إلى صداقة. ويأتيه الأعراب الغلاظ الجفاة صارخين: “أيكم ابن عبد المطلب؟” فيرضيهم النبي بما استطاع من جميل القول أو مديد العطاء، بوسع صدرٍ وصبرٍ في الاستماع إلى الناس جميعًا دون ضجرٍ ولا ملل، حتى يقول قائلهم: “جئتكم من عند خير الناس.”
وحكى الله تعالى مقال المنافقين فيه لما رأوا كثرة استماعه للناس واحتماله لهم: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}. فأشاعوا أنها ضعفٌ أو سذاجة رغم يقينهم أنها رفعةٌ ورحمةٌ بالغةٌ وهاجةٌ، فردّ الله عليهم بأنه أُذنُ خيرٍ لهم، أي يستمع للحق والصدق، رحمةً وعدلًا، يسمع ليهدي، ويُصغي ليقيم الحجة، ويحتمل الناس فضلًا منه لا عجزًا، ورحمةً لا ضعفًا. هكذا جمع النبي ﷺ بين الإصغاء الرحيم والحكمة في استيعاب الجميع، وهو يتحلّى بكامل الاتزان والعدل بل والفضل.
أما في القيادة، فقد أوصى كارنيجي بالمديح قبل النقد، وبالنصيحة اللطيفة بدل الأوامر القاسية. والإسلام قرر هذا المبدأ حين قال النبي ﷺ: “يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.” بل إن الخلفاء الراشدين طبقوا هذا عمليًا؛ فأبو بكر رضي الله عنه افتتح خلافته بقوله: “أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم.” إنها قمة القيادة التي تجمع بين التواضع والتحفيز والتكليف الأخلاقي.
والفرق الجوهري أن ما قدّمه كارنيجي يظل في دائرة المهارات الاجتماعية المرتبطة بالنجاح الدنيوي، بينما الإسلام جعل هذه المبادئ منهج حياة متكاملًا، يرتبط بالآخرة كما يرتبط بالدنيا، ويبني مجتمعات قائمة على الرحمة والعدل لا على المنفعة وحدها. فالإسلام لا يكتفي بأن تكسب الأصدقاء، بل يريد أن تكسب رضا الله أولًا، وأن تكون إنسانًا نافعًا رحيمًا، فتصنع أثرًا أعمق وأبقى.
وفي زمنٍ ازدادت فيه العلاقات جفافًا والتواصل سطحية، يعود الإسلام ليذكّر الإنسان بأن أساس القوة في اللين، وأصل القيادة في الرحمة، وأن بناء القلوب أعظم من بناء الممالك. فحيث انتهى كارنيجي عند فنّ التأثير، يبدأ الإسلام من عمق الإيمان، وما رآه العالم اكتشافًا حديثًا لم يكن إلا صدىً لما أشرق من معين النبوة الذي أنار للبشرية طريقها منذ قرون.
الخلاصة أن كارنيجي علّم العالم كيف يصل إلى القلوب عبر مهاراتٍ فعّالة، لكنها في حقيقتها مما استقاه من الهدي النبوي. أما الإسلام فقد جعل هذه المهارات جزءًا من الدين، فحوّلها من أدوات نفعية إلى عبادات ومعانٍ روحية تفتح لك أبواب النجاح الفردي والمجتمعي والإنساني، وقبل ذلك كله الأخروي المتوج بالرضا الرباني.
